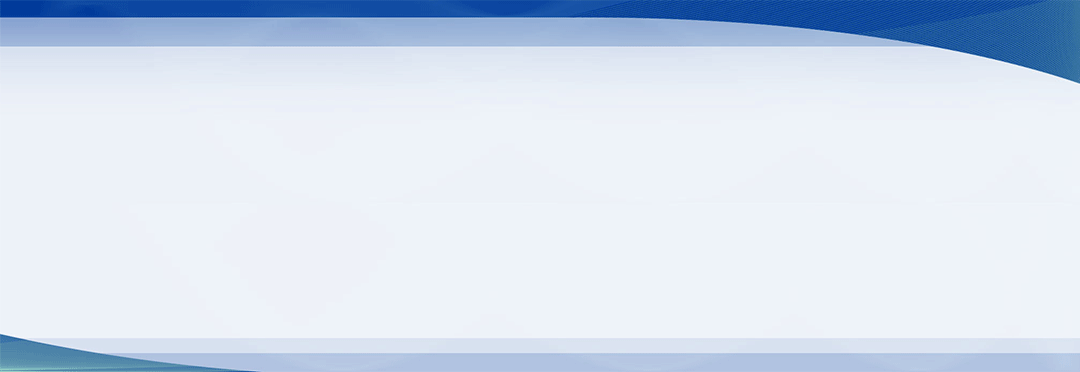الترند وعُقدة “اللامرئيّة” لدى اليمنيّ

تتوخّى هذه السطور _ من خلال ملاحظة واستقراء “ترندات” اليمنيين في السوشيال ميديا في السنوات الماضية_ محاولة تعليل الظاهرة وقراءة دلالاتها وأبعادها وما ورائها.
وتوسّع الرؤية إلى بواعث ونوازع ذلك في سيكولوجيا اليمنيّ، واستشفاف شيء من السمات التي تطبع شخصيته من كلّ ذلك.
مدخل فيما تقوله الأرقام:
من إحدى خيام الأعراس في صنعاء، أعاد الفنان صلاح الأخفش غناء “يا ليالي يا ليالي”، إحدى أغاني الفنّان إبراهيم الطائفي، فوصل فيديو الأغنية بطريقة ما إلى منصات مواقع التواصل الإجتماعي_ الخليجية منها على وجه التحديد_ ولاقى رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، وصارت الأغنية ترفق بمقاطع الفيديو، وأعاد الكثيرون غناءها، وصارت تُطلب في الحفلات الغنائية، وغناها فنانون معروفون كماجد المهندس على سبيل المثال..
بحمّى هذا الرواج تلقّى اليمنيون أغنيتهم، مشيّعةً باعتراف جعلها مختلفةً وفريدة هذه المرة، فلاقت رواجاً واسعاً، وانتشرت كالنار من منصّات مواقع التواصل وحتى أجهزة التشغيل في الدراجات النارية، وحضي صلاح الأخفش وباقي أغانيه باحتفاء وانتشار لم يكن ليحلُم به قبل ذلك.
ذات الشيء حصل مع شخصية “مصطفى المومري”؛ فالفيديوهات الأولى التي راجت له، كان فيها منكوش الشعر مهلهل الثياب، يتحدّث بفمٍ محشوّ بالقات، وكانت عناوينها من قبيل “اسمع ما يقوله هذا المجنون اليمني”..
ثمّ لم تلبث فيديوهاته الساخرةأو ما أجتزأ منها أن صارت “ريأكشنات” في دوائر الإنترنت الخليجية ذاتها، وانتشرت بشكل كبير كميمز تعبير فكاهي.
ليتلقّها اليمنيون بعد ذاك الإعتراف بحماسة واحتفاء مبالغ به، لدرجة أن حفل زفافه صار مظاهرة في ميدان السبعين، بل ذهبوا أبعد من ذلك فعدّوه رمزاً وصوتاً ثورياً في ظلّ سلطة القمع والقهر التي يحاولون التعايش معها.
وهو ما تنبّهت له السلطة حين اعتقلته، وخرج من السجن وقد صار مجنّداً في كتيبتها الإعلامية.
مثال آخر يؤكّد النمط، ويعزز ذات المسار، هو أغنية “قالت حبيبي” ومشاهداتها المليونية بعد عامين من نشرها في اليوتيوب دون أن يُلتفت إليها، والشهرة التي حضي بها صاحبها بعد ذلك يمنيّاً.
في الأمثلة السابقة نلاحظ تكرار ذات النمط، ونصل لذات النتيجة كلّ مرة..
قد يقول قائل إنّ ما سبق لا يعدو أن يكون من قبيل المصادفات التي لا تعني شيئاً، أو المشاهدات التي لا يصحّ تعميمها.
فلنعد إذاً إلى “ترندات” ما قبل مواقع التواصل، برامج المسابقات التلفزيونية على سبيل المثال، فطالما حكى لنا جيل الآباء بكثير من الفخر والعُجب عن المناظرة الشعرية بين فؤاد المحنبيّ وعباس فتوني، وكيف تفوّق المحنبي عليه وسحقه شعريّاً..
ولا يزال صوت أبي يرنّ في أذني وهو يقول بطريقةٍ مسرحيّة:
أيا عبّاسُ اسمُكَ فألُ عكسٍ
تُحاولُ أوّلاً فأقولُ سابع
شخصيّاً أصبت بخيبة أمل حين شاهدت المناظرة في اليوتيوب بعد كلّ ما سمعته عنها.
بدت لي قصائد المحنبي متواضعه، وطريقة الإلقاء باردة، بل ومتكلّفة ومملة، لكنّ المزاج العام تلقّها بالشكل الذي يريده، ويرضي حاجته لأعين تراه وأكفّ تصفق له، وقد جسّد المجموع في فرد، وألبس الشاعرَ البلاد.
وقل مثل ذلك عن مسابقات الغناء التي شارك فيها يمنيون، من فؤاد عبدالواحد وحتى ماريا قحطان.
كلّ مرة يعدّ اليمنيون تلك المشاركات قضايا وطنية، ويتفاعلون معها بعاطفة مشبوبة، وحماسةٍ مبالغ بها، اهتماماً وتخوّفاً وتصويتاً!
وفي كلّ مرة تعود بضاعة اليمنيّ إليه مختلفةً، بعد إشادة الآخر واستحسانه، كأنما يتعرّف اليمنيّ إلى ذاته بعد أن يراها بعين الآخر واعترافه.
وهنا يلمع في ذهني بيت البردّوني:
عرفتُهُ يمنيّاً، في تلفّتهِ خوفٌ
وعيناهُ تاريخُ من الرمدِ
وهذه هي المرّة الأولى التي انتبه فيها لعجز البيت ومعناه، فقد كنت أكتفي بالصدر في جميع قراءاتي السابقة له، وأمرّ بالعجز دون أن أحاول فهمه كأنما وجُد ليتمّ البيت ويوصل إلى القافية.
هاهو الآن يبدو لي تامّاً وواضحاً، شطراهُ جناحان يُحلّقُ بهما المعنى ويصل:
يتلفّتُ اليمني خارج وطنه؛ بحثاً عن أعينٍ تراه وتُلاحظُه وتعترف به، فهو لا يستطيع رؤية ذاته إلا بتلك الأعين ومن خلالها، فقد أصابته قرون التهميش وأزمنة التجاهل بالخوف ونزعت منه الثقة وأورثته العمى.
ويصحّ هذا القول في حالة البردّوني نفسه، فاحتفاء اليمنيين به واعترافهم بموهبته، لم يأتي إلاّ بعد أن سطع نجمه في مهرجان المربد الشعري، والتفت العرب لعبقريته واشادوا بشاعريته واستحسنوها.
وقل مثل ذلك في تجربة الفنان أبوبكر سالم، ولموع فنّه في عواصم الجوار ومسارحه قبل بلاده.
ولا يقتصر الأمر على الفنّ والأدب، بل يتعدّاه إلى مجالات أخرى كالوعظ الديني وعلوم الشريعة، فقد عاد الزنداني إلى اليمن نجماً بعد أن قدمته قنوات السعودية، بل إنّ أسطرته بين جموع المريدين كانت تتغذّى على ذات الثيمة التي نحنُ بصدد الحديث عنها، وهي حاجة اليمني لأن يُرى، فقد كان أتباعه لا يكفّون عن الحديث عن مناظراته وشعبيته خارج اليمن.
وأذكرُ سؤالاً اكليشيهياً كان يتكرر في مجالس وأسمار رمضان، ويتواطئ الجميع على الإندهاش به كلّ مرة!
يقول السؤال:
من هو العالِم الذي يعرفُه العالم ويجهله شعبُه؟
فتنبري للإجابة بكلّ ما في الطفولة من حماسة وتقول: الزنداني!
فتحفُّك الإبتسامات المستحسنة في الوجوه وتُعطى كتاب فتحي يكن “ماذا يعني انتمائي للإسلام” جائزة.
وبذات السمعة والنجومية عاد “مقبل الوادعي” إلى اليمن، تسبقه اشادات مشائخ الدين في السعودية وثنائهم عليه، كأنها صكوك تُحاز بها المكانة، وعرفان يُنال به الإعتراف.
بل إننا نستطيع الذهاب بعيداً، لنصل إلى زمن العلامة “محمد بن علي الشوكاني” وما عانه من الغمط والدسائس والوشايات في محيطه ومجتمعه، ولم يُلتفت لمكانته ويُعترف بفضله إلا بعد أن نال شهرةً خارج اليمن، ويحضرني في هذا السياق ملاحظة اجتماعية مُلفتة أوردها الشوكاني في أحد كتبه، حيث قال:
“إنّ كثيراً من أهل اليمن جُبلوا على غمط محاسن بعضهم، ودفن مناقب أفاضلهم، وإنّي لأتعجب من اختصاصهم بهذه الخصلة التي كانت سبباً لدفن سابقهم ولاحقهم، وغمط رفيع قدر عالمهم وفاضلهم وشاعرهم، وسائر أكابرهم، ولهذا أهملهم المصنّفون في التاريخ على العموم”.
فإن راودك هنا تساؤل:
ما بالهم يحتفون بآحادهم بعد احتفاء الآخرين، خلافاً لصنيعهم معهم قبل ذلك؟
أجبتُك أن هذا ما نُدندن حوله منذ البداية، الإحتفاء بأثر رجعي يشبع تلك الحاجة إلى “الرؤية”، بعد أن جردت الجموع الفردَ من ذاتيته وجعلته رمزاً لها، به تُرى وعن طريقه يُلتفت لها.
أذكر شاعراً في إحدى القرى، كان يتعرّض لحملات ممنهجة من التهكّم والسخرية بقصائده، والثلب لجودة أشعاره وعدّها من قبيل أماسي شعبان وأغاني العجائز..
غادر الشاعر القرية وذاع صيته وشعره، فصار أهل تلك القرية “المتنمّرة” يفاخرون أنه ينتمي إليهم ونبغ بينهم.
اليمنيّ الذي لا يُرى:
في 2003 كان “صالح عبدالله” يعمل في جربته وقد أسند الراديو لأحد أعواد الذرة، ليتابع منه أخبار العراق..
فما فتئ اليمنيّ مهتمّاً بكل أخبار العرب ومآسيهم، وكلّ مرة يجد نفسه وحيداً في مآسيه.
يعبّر شاعر الشعب ولسانه”عبدالله البردّوني” عن ذلك قائلاً:
وأنا أكدى الورى عيشاً
على أنني أبكي لبلوى كلّ مكدي
حين يشقى الناس أشقى معهمُ
وأنا أشقى كما يشقون وحدي
بدافع هذه المعضلة صنّف الزبيري كتابه “مأساة واق الواق” بغية تعريف العرب بالقضية اليمنية، فجمع فيه الجنّ والإنس والملائكة والشيطان، واستبق القيامة ليضع القضية اليمنية على طاولة العدالة الإلهية، محاولاً شرحها لهم.
ثم نجده يقول بعد ذلك:
إنّ الشعب العربي في اليمن عاش نصف قرن مجفوّاً من إخوانه العرب، ومهملاً ومنسيّاً، ولا يكاد العرب يذكرون هذا الشعب، أو يعترفون بوجوده القومي،إلا عندما تلوح لهم إشارة من جلاديه،أو حينما يتكرم الجلاد ويتعطف ويتلطف بابتسامة أو تحية إلى الأمة العربية، أو عندما يظهر في فصل من فصول مسرحياته
ويخلع على نفسه أثواب البطولة المزورة، فعندئذ تتحرك أجهزة الدعاية العربية وتنطق الاسم المهمل الضائع (اليمن).
أمّا البردّوني فقد ناقش ذلك في قصيدته “يمنيٌّ في بلاد الآخرين” وفيها يقول:
من أين أنا؟ من يدري؟
أوليست لي جنسيّة؟
يا اخواني أصلي من
صنعا، أمّي دبعيّة
صنعاويٌّ حجريٌّ
ما صنعا؟ ما الحُجريّة؟
من أين أنا؟ تشويني
بتغابيها السُخريّة
عربيٌّ لا تعرفني
حتّى الدنيا العربية
يا ريحُ بلادي خلفي
ومعي مثلي منسيّة
ومن السخرية الموجعة أن هذه القصيدة التي يعبّر فيها البردّوني عن شعور اليمني بالتجاهل من محيطه العربي، والتناسي من اخوته العرب، غنّتها “تانيا صالح” قبل سنوات، وحذفت منها كلّ الأبيات التي تشير إلى اليمن، لتؤكد الشكوى وتذرّ الملح على الجرح، فاللعجب بل ياللمرارة!
من ما سبق نستطيع فهم الكثير من الظواهر التي نكتفي دائماً بالسخرية منها، دون قراءتها وتتبّع جذورها وأسبابها، مثل فيديوهات “اليوتيوبرز” العرب عن اليمن وعن فزعة اليمنيين، لينالوا بها لايكاتهم ومشاهداتهم. فيحصُل لهم ذلك كل مرة، فهي تتغذّى على تلك الحاجة للرؤية والحضور لدى اليمنيّ، وتلعب عليها وعلى ما ينتج عنها من سلوك.
ونستطيع أيضاً أن نفهم ظاهرة “الزنبلة” بعد السابع من أكتوبر وعمليات البحر الأحمر، وكيّف تغيّرت أراء كثير من اليمنيين بعد أن صارت تلك العمليات “ترنداً” لدى العرب، وملئت حاجة اليمنيّ لأن يُرى، فصار الكاتب محمود ياسين يستخدم مصطلح “اليمن العزيز” الذي صُكّ في الضاحية الجنوبية بدلاً من “اليمن السعيد”.