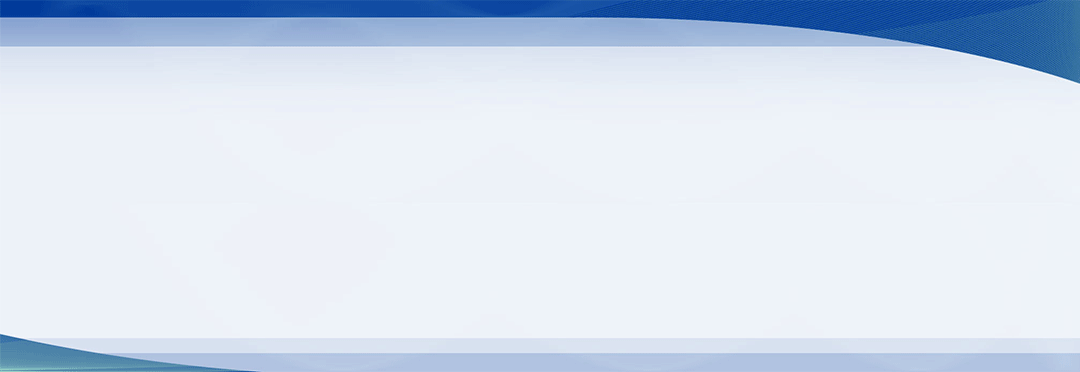حين نصقل وجوهنا لنمحوها

بدر مصطفى:
ثمة إشراقة ما تنساب في وجوهنا في مقتبل العمر، أشبه بوعد غير مكتوب يعدنا به العالم بأننا سنظل كما نحن زمنًا طويلًا؛ إشراقة تتسلّل في نضارة الجلد، وفي مرونة الحركة، وفي البريق الخاطف الذي يلمع في العيون حين نضحك أو نعجب بشيء ما. في تلك الفترة، تكون قدرتنا على تخيل أنفسنا وقد هرمنا وفقدنا مقومات شبابنا محدودة، وهذا أمر طبيعي لأن إحساسنا بالزمن آنذاك هو انعكاس لطاقة حيوية تتواثب داخلنا دون سيطرة. غير أن تلك الإشراقة تبدأ، عامًا بعد عام، في التراجع. نكتشف ذلك في صورة قديمة، أو في تعليق عابر من صديق غاب عنا منذ فترة، أو حتى في انعكاس المرآة حين يصبح أكثر وضوحًا من أن نتجاهله. عندئذ قد تجد الأسئلة القلقة طريقها داخلنا: كيف نوقف هذا الانسحاب البطيء؟ كيف نُقنع أنفسنا أن الوجوه لا تزال تحمل إشراقتها الأولى؟ وتلك بالضبط هي اللحظة التي تبدأ فيها بعض الوجوه رحلتها الجديدة في فضاءات خارجية أُعدّت لمقاومة الزمن ولاستقبال هذه الأسئلة القَلِقة..وإسكاتها!
لكن قبل أن نمضي في تحليلنا، لنتوقّف قليلًا عند مكوّنات غرفة أُعدّت بعناية لاستقبال تلك الهواجس. غرفة يغمرها ضوء أبيض شديد السطوع، يكاد يُعرّي كل ذرة في الوجه. على جدرانها تتقابل المرايا وتتكاثر انعكاساتها، مثل عيون متربّصة أو كاميرات مراقبة سرّية، لا تُفوّت خطًا دقيقًا في الوجه، ولا شعرة شاردة، ولا ظلًا خفيفًا يشي بأن الزمن مرّ من هنا. في الوسط طاولة مرتبة بعناية، تصطف عليها قوارير الكريمات والسيرومات، وتحرسها أدوات دقيقة تَعِدُ مَن يجربها بأنّ الساعات ستتباطأ. هنا يمكنك أن ترى الكثير من الوجوه الجامدة، التي صقلت وشدت وحقنت، فتعاملت مع العمر كما لو كان دخيلًا يمكن طرده من تحت الجلد بحقنة واحدة. تخرج الوجوه من هذا المكان لامعة وشبه متطابقة، كما لو كانت قد وُضعت داخل فلتر أبديّ من فلاتر السناب شات. وعلى الجدران شاشات ولوحات ضخمة، تكرّر العبارة ذاتها “شبابك اختيارك”، تتدلى تحت شعار عبارة عن شمس مشرقة محاطة بأفعى دائرية. ستجد نفسك محاصرًا بعدد غير محدود من الصور لابتسامات بيضاء مشرقة ووجوه لا تعرف للتجاعيد أثرًا، وأجسادًا مشدودة مشحوذة لا مكان فيها لوهنٍ أو ترهّل.
هكذا هي ثقافة اليوم: جسدٌ تحوّل إلى ساحة معركة، وزمنٌ صار عدوًا صريحًا. نطارد الإشراقة التي بدأت تخفت ببطء، ونحاصر العلامات الصغيرة التي يتركها العمر على وجوهنا، وننفق أعمارنا في محاولة لسترها، كما لو أن الجمال لا يكتمل إلا إذا أُفرغ من كل أثر للحياة التي مرّت عبره.
لكن إذا كان الوجه هو الواجهة الأوضح لإكراهات الصورة المثالية، فإن الجسد هو امتدادها الكلي. وهنا لا نتحدث عن خطوط دقيقة أو ملامح محدودة، بل عن لحم وعظم وجلد يتعرض لإعادة تشكيل متواصلة. لم يعد الجسد في عصرنا موطنًا للذات، بل مشروعًا للتدخل؛ مشروع يشتغل عليه المجتمع كما يشتغل النحّات على الحجر الخام: يقصّ، وينحت، ويضيف. نظام دقيق من الصيانة والإخفاء يتسلّل إلى تفاصيل الحياة اليومية: من الحمية الغذائية إلى جراحة التجميل، ومن الصالات الرياضية إلى أنظمة النوم المحسوبة بالثواني. ولأن الجسد لم يعد مسموحًا له أن يشيخ أو يضعف أو يتداعى، أصبح البعض محكومًا بقاعدة صامتة: أن يظهر دائمًا كما لو أنه في مقتبل العمر. هذه العملية لا تدخل بالتأكيد ضمن حرية الاعتناء بالذات، بل هي شكل من أشكال الاستلاب؛ استلاب يُجبر الجسد على التمثيل في ساحة لا تعترف بإمكانية فشله وهشاشته، كما لو أن الوجود نفسه لا يُقاس إلا بدرجة التناسق العضلي، وشدة الجلد، ونعومة البشرة.
ثمة فرق كبير بين الاعتناء بالجسد، كنوع من الوفاءً له والإصغاءً إلى حاجاته، والهوس بمحو علامات الزمن منه. الاختلاف جذري بين أن نصون الجسد ليحيا معنا بكامل طاقته، وأن نُخضعه لاستنفار دائم كي يُخفي الزمن الذي يمرّ فيه. هذا الاستنفار يحول الجسد إلى مساحة إنتاج، يجب أن تُدار وتُحسَّن، حتى وإن كان الثمن هو محو العلامات التي تمنحه فرادته.
الخوف من اضمحلال الجسد وموته رفيق قديم للإنسان، ظل يلازمه عبر العصور بوصفه جزءًا من وعيه بذاته وحدوده، وهو خوف طبيعي لا يُمحى ولا يهدأ. غير أنّ مواجهته عبر مطاردة الجسد وصقله لا تُبدّد هذا الهاجس، بل تضيف خوفًا آخر فوق هذا الخوف الوجودي، وتجعل الحياة أكثر إرهاقًا. فكما يُطلب منا أن نعمل أكثر وننتج أكثر، يُطلب من وجوهنا أن تبقى متيقظة، ومن أجسادنا أن تقترب من صورة مثالية متخيلة، ومن أعيننا أن تظل لامعة حتى في لحظات الإنهاك القصوى. وهكذا يتحوّل الجمال إلى صورة إنتاجية جديدة، تخضع للرقابة والمعايير، وتغدو عبئًا إضافيًا نضعه فوق قائمة أعبائنا الحياتية.
والمفارقة الواضحة في الجمال المصقول، أنه رغم كل محاولات التحسين، يظهر فاقدًا للحياة. فالوجوه التي تُمسح منها الندوب والتجاعيد لا تحكي شيئًا، لأنها أخفت القصص والتجارب التي كانت تمنحها الحياة. وكما أن اللوحة التي يُعاد صقل ألوانها حتى تصبح لامعة وموحّدة تفقد عمقها وظلالها، كذلك يفقد الجمال طابعه الإنساني حين يُطهَّر من الشوائب التي تُذكّرنا بأننا بشر، وبأن الجسد يمتلك ذاكرته الخاصة من تجارب وخبرات.
إن مقاومة الزمن بهذا الشكل اليائس لا تفضي إلى الانتصار عليه، ولو بشكل عابر، بل إلى استنزاف الحياة في محاولة بائسة لتجميدها. والعمر الذي ننفقه في مطاردة صورة لا تشيخ هو نفسه العمر الذي نتنازل فيه عن أن نعيشه بامتلاء وصدق. فالزمن، مهما حاولنا صده، يمضي؛ لكننا حين نحاول محوه من ملامحنا، نحجب بذلك صورتنا الأصدق؛ الشاهد الحقيقي على حياة عشناها.
توهمنا مقاومة الزمن أننا نحافظ على حياتنا، لكنها في جوهرها تجعلنا نعيش في حالة تأهب دائم. نراقب أجسادنا كما يراقب المرء ممتلكًا يخشى ضياعه. وبدلاً من أن نحيا في اللحظة، نصبح حرّاسًا على مظهرنا. نُعيد قياس المسافات بين الأمس واليوم، ونُفتّش عن أي خلل في السطح. كل إصلاح يجرّ إصلاحًا آخر، دون أن نصل يومًا إلى لحظة نقول فيها: هذا يكفى. ومع الوقت، تصبح معاييرنا للجمال مرهونة بقدرتنا على إخفاء العيوب، وليس الاحتفاء بما تبقّى لنا من أثر للحياة علينا.
وما محاولات محو الزمن من وجوهنا وأجسادنا سوى وجه آخر للتشبّث بالدنيوي. تعلقٍ متوتر بما يزول، ورغبةٍ في تمديد ما كُتب له أن ينقضي. فهي تنكر على الإنسان وعيه بمحدوديته، وتضعه في تناقض مع حقيقة وجوده العابر، كأن بوسعه أن يوقف الرحيل أو يؤجّل الموت. غير أن هذا الانشغال، من المفترض، ألا يصمد أمام أفقٍ آخر ينشده الإنسان في أعماقه؛ أفق لا مكان فيه للزمن بمعناه المادي، ولا للعلامات التي تُثقِل الجسد، بل لحضورٍ أصفى يتجاوز ما يذوي وما يفنى.
أخيرًا، الزمن لا يُقاوَم بالمحو، بل بالإنصات إلى علاماته بوصفها جزءًا من اكتمالنا. والتصالح مع مراحل حياتنا المتقدمة ليس استسلامًا، بل وعيًا بأن الجمال، متى صُقل، حتى مُحى منه أثر العيش، فقد جوهره. فالجمال، ليس وعدًا بالخلود، بل أثرًا يتشكّل مع كل حياة تمضي تاركةً على وجوهنا علاماتها التي لا تضاهى.
المصدر: معنى.