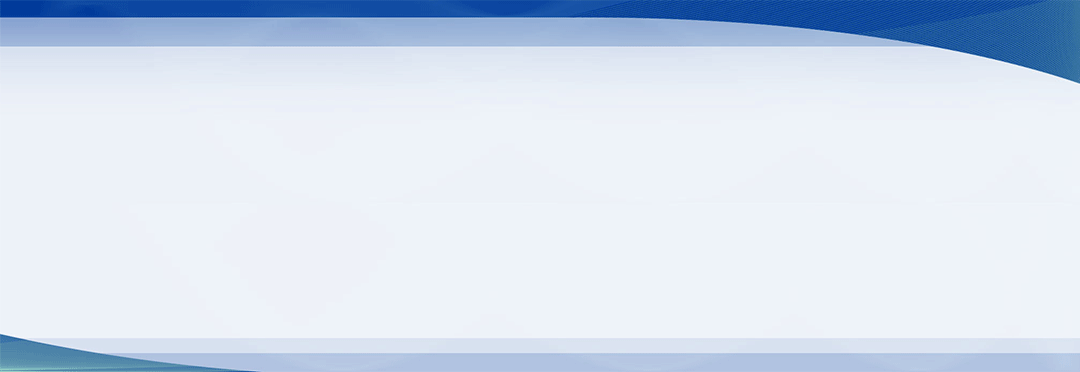صدور كتابي الجديد، وهذا العرض كما وعدتكم: التاريخُ المُقَنّع: هل التاريخُ حدثٌ أم فكرة؟، نقد أطروحات التوراتيين العرب

صدور كتابي الجديد، وهذا العرض كما وعدتكم:
التاريخُ المُقَنّع: هل التاريخُ حدثٌ أم فكرة؟، نقد أطروحات التوراتيين العرب
الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم. بفضل من الله وكرمه وعونه، صدر كتابي الجديد ابن الثماني عشر ربيعًا، عن دار “زهراء الشرق” بالقاهرة التي تأسست منذ نحو 89 عامًا.
فقد أُنجز هذا الكتاب خلال الأعوام بين (2007 – 2025م) وسط سيل من مؤلفات تجتهد لنقل جغرافية التوراة إلى الجزيرة العربية، وعلى وجه خاص بلاد اليمن، وعسير، وصولًا إلى مكة المكرمة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، دون كلل ولا ملل.
وإزاء ذلك رأينا أنه لا بد من صدور عمل علمي شامل بغرض الكشف المنهجي عن حقيقة أطروحاتهم، وهو ما نرى أنه تحقق في هذا الكتاب، الذي تناول بالنقد العلمي المنهجي تلك المؤلفات، التي غاب عنها تحري الموضوعية، والدقة المنهجية، وربما التحيز لخلفية أيديولوجية صارت نوازع تتحكم في أقلامهم وتفكيرهم، وهي إشكالية أحدثتها وستحدثها تلك المؤلفات التوراتية حاضرًا ومستقبلًا من حيث تشويش واضطراب الذاكرة الجمعية للأمة، وخاصة جيل الشباب المتحمس، الأمر الذي يجعل التصدي المنهجي العلمي لها من واجبات البحث العلمي المتخصص.
ناقش هذا الكتابُ أطروحاتِ فاضلَ الربيعي وعَشَرةً آخرين، وأثبت قُدرةَ التاريخِ على تبديدِ الجغرافيا المتخيلة، فلا جغرافيا بلا تاريخ، ولا تاريخ بلا جغرافيا، وهو المأزق الذي وقع فيه “جماعةُ التاريخِ المُقَنّع”، فاضطروا إلى إسدالِ قناعِ الوهمِ على الحقائقِ فزادهم ذلك رهقًا، وحَشَرَهُم في مأزق منهجي وعلمي جَعَلَهُم يتنقلون من وادٍ إلى وادٍ، ومن جبلٍ إلى جبل. وحين أرادوا (صناعةَ) تاريخٍ متخيل، لم يجدوا بُدًا من إسدالِ القناعِ على دولٍ وملوكٍ، ثم إحلال تصور بديل، فزاد الخرقُ اتساعًا صَعُبَ عليهم رتقه، وفي الوقت نفسه صَعّبَ عليهم التراجع، فتناقلوا الغلةَ الفاسدةَ من شخصٍ إلى آخر، لِتُقَدّمَ هنا بثوبٍ، وهناك برداءٍ مختلف.
إنه “التاريخ المُقَنّع”. هذا هو المصطلح التاريخي الجديد الذي يُقدّمُ لأول مرة، ليكون الوعاء الذي أطلقناه على مؤلفات التوراتيين العرب.
عَرّفنا مصطلح “التاريخ المُقَنّع”: أنه عمل انطباعي يعتمد على نقل الجغرافيا من بلد إلى آخر بعد تحريفِ وتجريفِ ومسخِ أسماء المواقع الجغرافية في البلد الأصل، والبلد المقترح على السواء، ثم تلفيقها بشكل تعسفي إلى الجغرافيا الجديدة. كما أنه لا يقوم على منهج علمي متكامل، ولا على بحث رصين، فهو يعتمد منهجًا أُحاديًا أساسه المقابلة بين الأسماء والألفاظ لإثبات الفكرة، في حين يتجاهلُ النصوصَ التاريخيةَ في حضارات الشرق القديم والجزيرة العربية، ونتائجَ التنقيباتِ عن الآثار بالمطلق، ويؤمن فقط بصحة النص التوراتي، وخطأ الجغرافية التوراتية. وغايته أن يُقدِم تأريخًا متخيلًا، من خلال نقل الوقائع التاريخية الحقيقية ثم إسقاطها على خارطة الخيال الجغرافي المنفلت، ليعيد رسم المشهد التاريخي المتخيل بأساليب الاجتزاء والانتقاء، وادعاء وقائع غير صادقة، ودمج العصور والمراحل التاريخية، بصرف النظر عن الأقدم والأحدث، وبطريقة تدل على عدم فهم التاريخ، بل تَعْمَدُ إلى تشويهه، ثم إعادة تقديمه بقناع مُختلق ليظهر وكأنه حقيقة.
وعلى العموم، نتوقعُ أن هذا المصطلح الجديد الذي يؤطرُ أعمالَ “التوراتيين العرب” سيجعلهم يُعرَفون من الآن “بجماعة التاريخ المُقَنّع”. كما نتوقع أنه سيتعدى تَخَصُّصَهُ الدقيق ليرتبطَ بين الدراسين والمثقفين بجوانبَ شتى، تعبر عن كل معنى يُخفي في طياتهِ جوانبَ مُضْمَرَة، كقولنا: الفكر المُقَنّع، والثقافة المُقَنّعة، والسياسة المُقَنّعة، والاقتصاد المُقَنّع، والاستثمار المُقَنّع، والأيديولوجيا المُقَنّعة، والتعبير المُقَنّع، والمواقف المُقَنّعة، والكتابات المُقَنّعة، والسرديات المُقَنّعة … وغير ذلك. بمعنى أن هذا المصطلح سيصبحُ أسهلَ تعبيرٍ عن الفكرةِ الزائفةِ، أو المُلْتَوِيَةِ، أو التخطيط غير الصادق أو غير الواقعي، سواءٌ على المستوى الفردي، أو الجماعي، فهو مصطلحُ وعاءٍ لكل الحالات المتشابهة مع سياقه وتركيبه ونماذجه.
كما تطرقنا خلال شرح المصطلح إلى توضيح الفرق بين “التاريخ المُقًنّع” وكل من “التاريخ المُزَوّر” و”التاريخ المُحَرّف”. وكذلك الفرق بين “الفكرة التاريخية” و”التاريخ الفكرة”، في سياق الإجابة على السؤال المركزي للكتاب، “هل التاريخ حدث أم فكرة؟”. وأيضًا الفرق بين “مصطلح الوعاء” و”مصطلح الحالة”، وكلها مصطلحات جديدة كذلك، نقدمها لأول مرة.
ومثال ذلك:
بالنسبة لـ (مصطلح الحالة) (ومصطلح الوعاء)، ضربنا مثلًا (بالفتنة) التي كانت مصطلح حالة، بمعنى أنها ابنة زمانها وانتهت كأي حادثة تاريخية، ثم تحولت إلى مصطلح وعاء، تضم كل أنواع الشرور والصراعات العابرة للأجيال وبصورة باتت تشكل عبئًا على الفكر الإسلامي برمته، وانقسامًا خطيرًا للأمة.
قَسّمْنا هذا الكتاب الذي بلغت عدد صفحاته (446) صفحة، وعززناه بمراجع علمية دقيقة بلغت حوالي (225 مرجعًا) إلى ثلاثة أقسام: تطرقنا في القسم الأول، وعنوانه: (المدخل النظري والدراسات السابقة) (الصفحات 17 – 172)، إلى مفهوم التاريخ المُقَنّع، الذي أنتجناهُ للتعبير عن مضمونِ الكتاب (ص 19 – 24). ومنهجية كتابة التاريخ القديم، كي يَعرفَ القارئُ، كيف يُكتبُ التاريخ، وكيف خالف المُقَنِّعون (التوراتيون العرب) ذلك حتى غَرِقوا في “اليمّ” وهم يبحثون عن فِرعوْنَ وجنوده (ص 24 – 33). تلا ذلك تعريف بجماعةِ “التاريخ المُقَنّع” (التوراتيين العرب) ومؤلفاتهم ومنهجهم السردي وخصائصه (ص 33 – 45).
لقد كشفنا في هذا القسم عن حقيقة وسر مئات وآلاف النقوش العبرية التي ادعى فاضل الربيعي أنها في اليمن، وهو السر الذي أدان الربيعيُّ به نفسه، ودل على جهله المطلق بالتاريخ ومصادره. والحقيقة أنه شاهد مدونات النقوش اليمنية القديمة (CIH وRES ) حيث كُتبت نقوش المسند فيهما بالحرفين المسند والعبري لتسهيل قراءة الحروف بحسب منهج من كتبها، ثم استُبدِلَ الحرف العبري كما هو معروف بالحرف اللاتيني، ثم بالحرف العربي واللاتيني بحسب طبيعة لغة البحث. وأوردنا -كمثال على ذلك- أربع صور من صفحات المدونتين التي أغرت الربيعي وجعلته يدعي جهلاً أن في اليمن آلاف النقوش العبرية؟!، وهذه نتيجة طبيعية يصل إليها من يمتطي صهوة التاريخ بلا دراية ولا اختصاص.
وحرصنا بعد ذلك على إبراز الدراسات والكتابات السابقة، (ص 57 – 172) كمتطلب سبق أن نادينا به لُيطَبّق على مستوى الجامعات في رسائل الماجستير والدكتوراه، وعلى مستوى الدوريات العلمية، في الأبحاث، كوسيلة للقضاء على ظاهرة السرقات العلمية. وغايتنا من عرضها، هو بيان أهميتها كإسهامٍ مُشَرّف لأصحابها، وحقٍ محفوظٍ لهم، ولتعزيزِ كتابِنا بما قَدّمَتْهُ تلك الجهود القيمة وحَرِصَتْ على بيانه، ومن ثم عدم الانشغال بإعادة تقديم ما سبق دراسته، بل التفرغ لتقديم الجديد مع الاستشهاد بتلك الدراسات عند الحاجة إليها. فشملت خمس دراسات، وعرضان نقديان، وأربعة مقالات، وهي على النحو الآتي مرتبة بحسب أقدمية صدورها:
أولًا: الدراسات
أ.د عبد المنعم عبد الحليم سيد.
أ.د فراس السواح.
أ.د عفيف بهنسي.
الأستاذ فكري آل هير.
أ.د عبد الله بن أحمد الفيفي.
ثانيًا: العروض النقدية
أ.د محمود أبو طالب.
المؤرخ الأستاذ علي سدران.
ثالثًا: المقالات
الشيخ حمد الجاسر.
أ.د عبد العزيز المقالح.
أ.د سليمان بن عبد الرحمن الذييب.
أ.د عبدالله أبو الغيث.
أما القسم الثاني (ص 175 – 297) من الكتاب، وعنوانه: (أطروحات فاضل الربيعي: مرتكزات خاطئة ونتائج متخيلة)، فتناول فصله الأول هدم مرتكزات الأستاذ فاضل الربيعي الخاطئة (ص 177 – 211) التي حددناها في مرتكزات ثلاثة، تنطبق في المجمل على أطروحات “جماعة التاريخ المُقَنّع”، وهي:
1-سبأ وحمير وربطهما بإسرائيل ويهوذا رغم أنهما لا تلقيان ولا تزامن بينهما على الإطلاق، وقد وضحنا ذلك بالنقوش والشواهد التي لا تخفى على متخصص. فقد خلط الربيعي بين المكرب السبئي “كرب إيل وتر”، والملكين الحميريين: “كرب إيل وتر يهنعم” ملك سبأ وذي ريدان (40 – 70م) أي في القرن الأول الميلادي، والملك “كرب إيل وتر يهنعم ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت (311 – 314م) أي القرن الرابع الميلادي.
هذه الكارثة قادته إلى وصف الملك السبئي “كرب إيل وتر” بأنه ملك سبأ وذي ريدان، فجعله يحكم من القرن السابع ق.م وحتى القرن الرابع الميلادي، أي حوالي ألف عام؟! وعلى ذلك أحل ما أسماه بجغرافية وتاريخ إسرائيل ويهوذا محل سبأ وحمير، واخترع تاريخًا جديدًا لحمير قبل ظهورها على مسرح الأحداث كدولة بحوالي ستة قرون. هذه أمثلة فقط لكثير مما سيجده القارئ مُوَثقًا في الكتاب. (ص 177 – 185).
2- مصر التي جعلها في الجوف باليمن في مفارقة تاريخية مخجلة، وناقشناها بالتفصيل نقاشًا مُوَثقًا في ضوء نصوص المسند، والنصوص العراقية القديمة. فقرر الربيعي أن مستوطنة المعينيين التجارية التي أقاموها في العلا بالمملكة العربية السعودية في حوالي أواخر القرن الرابع ق.م أو مطلع القرن الثالث ق.م، هي مصر التوراتية، وجعلها تصارع الآشوريين في القرن الثامن ق.م، أي قبل ظهورها بأربعة قرون؟! وهذه هي مصر الربيعي التي فرق بينها وبين مصر الإقليم على حد وصفه. كما قدمنا وجهة نظرنا في موضوع اسم مصر نفسه، وعديناه وفقًا للشواهد اسمًا أجنبيًا أطلق عليها، كما حدث للكنعانيين الفينيقيين، والإغريق. (ص 185 – 201)
3- فرعون، الذي أنكر الربيعي وغيره وجود هذا اللقب في الكتابات المصرية القديمة، وأوردنا نماذج أصلية من تلك النصوص الهيروغليفية (المصرية القديمة) الكثيرة التي ذكرته، كما تطرقنا إلى ما جاء عنه في نقوش المسند المتأخرة. (ص 201 – 211)
وتحت عنوان: “حين يُبدّد التاريخُ الجغرافيا المُتَخَيّلة” جاء الفصل الثاني (ص 211 – 239)، الذي ناقشنا فيه أساليب تقنيع التاريخ من قبل جماعة التاريخ المُقَنّع، وكيف حوّل هؤلاء التاريخَ من حدثٍ يقوم على الدليل الأثري والنص التاريخي إلى مجرد فكرة متخيلة لا أساس لها على الأرض، ولا وجود لأصدائها في تفاصيل القصة التاريخية العابرة للأجيال، معتمدين المنهج العلمي والدليل الوثائقي، بصرف النظر عما يرضينا وما لا يعجبنا، من منطلق أن العلم لا يتعامل مع الأسماء والأمنيات، بل مع الوثائق والاستقراء الموضوعي، بعيدًا عن العواطف. وضربنا أمثلة عديدة على ذلك.
كما أوضحنا حقيقة الحملات الآشورية على اليمن التي يدعيها الأستاذ فاضل الربيعي (الصحفي والروائي)!
ركزنا في هذا القسم على نقد نماذج من ثمانية كتب من كتبه، هي:
1-إبراهيم وسارة: الهجرة الوهمية إلى فلسطين.
2-يهوذا والسامرة: البحث عن مملكة حمير اليهودية، (إسرائيل المتخيلة: مساهمة في تصحيح التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة).
3-مصر الأخرى، إسرائيل المتخيلة: مساهمة في تصحيح التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة، المجلد الأول، الكتاب الثاني.
4-بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر.
5-القدس ليست أورشليم: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين.
6-فلسطين المُتَخَيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم، مج1.
7-فلسطين المُتَخَيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم، مج2.
8-يوسف والبئر: أسطورة الوقوع في غرام الضيف.
وقد توزعت النماذج المختارة من هذه الكتب والاستشهادات في كل فصول هذا القسم، وخلصت جميعها بحسب الشواهد والأدلة المادية، إلى بطلان أطروحات فاضل الربيعي العبثية، ومن ذلك -على سبيل المثال- الخلط بين الملك السبئي “كرب إيل وتر”، والملوك الحميريين الذين يحملون الاسم نفسه، كما أسلفا. أو حين ينكر وجود الملكين المصريين “شيشانق الأول”، و”نيخاو الثاني” في سياق التاريخ المصري القديم وتلفيقهما إلى جغرافيا اليمن وتاريخها القديم بشكل بشر أو جماد؟! وقد بددنا هذا الطرح بالنصوص والآثار والأدوار التاريخية لهما في تاريخ مصر القديمة، والتي أرفقنا صورها كوثائق دامغة لوأد الجهل وتصحيح الخطأ. مع العلم أنهما من الملوك الذين شملتهم أطروحتنا للدكتوراه!، كما قُدّما في كتابيّ “تاريخ وادي النيل: مصر والسودان”، و “فلسطين وفينيقيا في سياسة ملوك مصر الفرعونية”.
أو حين ينقل معارك تاريخية للآشوريين دارت في شمال العراق التي ذكرت النصوص المسمارية جبالًا فيه باسم “مصرو”، إلى وديان اليمن وجبالها، أو معارك دارت بين ملوك مصر القديمة والعراق القديم في بلاد الشام، وكأنه يتسلى بلعبة إلكترونية.
وجاء الفصل الثالث بعنوان: أساليب تقنيع التاريخ من قبل “جماعة التاريخ المُقَنع” (نماذج تطبيقية. (ص 271 – 300)، واكتفينا بنماذج من كتابين من كتب فاضل الربيعي، وهما: “مصر الأخرى” و “يهوذا والسامرة”. حيث نقل جغرافية التوراة برمتها إلى بلاد اليمن، وعدّ ذلك “نتائج ثورية؟!”، حين زوّر قراءة النصوص والنقوش بطريقة (ثورية!)
في القسم الثالث من الكتاب، وعنوانه: (جماعة التاريخ المُقَنّع بين بيضة “الديك” وحليب “التيس”: قدمنا عرضًا نقديًا لإثني عشر كتابًا مرتبة بحسب صدور الطبعة الأولى) (ص 301 – 419).
تضمنت العروض النقدية، موقف العلماء من أطروحة الدكتور اللبناني كمال الصليبي (خريج العلوم السياسية المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط) في كتابه “التوراة جاءت من جزيرة العرب”، باعتباره الأب الروحي والفكري لهم (ص 305 – 310)، مع عرض نقدي منهجي علمي لإثني عشر كتابًا (ص 310 – 419)، لكل من:
الدكتور زياد منى (تخصص الدراسات التوراتية) في كتابه “جغرافية التوراة مصر وبنو إسرائيل في عسير”، والأستاذ فرج الله صالح ديب، من لبنان (تخصص علم الاجتماع) في كتبه: “اليمن هي الأصل: الجذور العربية للأسماء”، و”التوراة العربية وأورشليم اليمنية”، و”اليمن وأنبياء التوراة”، والأستاذ أحمد عيد، من مصر (تخصصه غير معروف) في كتابه “جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة”، والأستاذ فضل عبد الله الجثام اليافعي من اليمن (المتخصص بالعلوم السياسية والقانون) في كتابه “الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى القديم: سبر في التاريخ القديم”، والدكتور لطيف إلياس لطيف، من لبنان (تخصص الفلسفة) في كتابه “لبنان التوراتي في اليمن”، والأستاذ أنور محمد خالد من اليمن، (تخصصه غير معروف) في كتابه “مهد العرب، الفراعنة كنعان الآراميون، والأمويون”، والدكتور أحمد الدبش من فلسطين (تخصص الحقوق)، الذي كتب اعتذارًا شجاعًا عن أفكاره تحت عنوان: “عودة عن خطأ السنوات المبكرة: لم يحتضن اليمن ملوك بني إسرائيل”، وقد ناقشنا كتابين من كتبه هما: “كنعان وملوك بني إسرائيل في جزيرة العرب”، و”اختطاف أورشليم”. والدكتور أحمد بن سعيد قشاش من السعودية (تخصص البلاغة) “أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة”، واكتفينا فيه بما كتبه عنه المؤرخ السعودي “علي سدران”. والطبيب محمد منصور من لبنان (طبيب النساء والتوليد) في كتابه “التوراة الحجازية تاريخ الجزيرة المكنون”، الذي نقل أرض الميعاد إلى وادي القرى، وأورشليم إلى مكة المكرمة، وجعل الحرم المكي الشريف “هيكل سليمان”، والكعبة المشرفة “قدس أقداس الهيكل”، وهو ما يعد تطورًا جديدًا ومريبًا في غايات وأهداف “جماعة التاريخ المُقَنّع” والذي توقفنا عنده طويلًا (ص 366 – 410).
وفي هذا الصدد يقول محمد منصور في نهاية خاتمة كتابه أن ما يقوم به هو: “دعوة للرجوع إلى قبلة إبراهيم الحقيقية التي توحد ولا تفرق، القبلة التي تنبأ يسوع للسامرية بإعادة الكشف عنها، والتي هي بيت الله الحرام بمكة؛ لا القدس ولا نابلس”.
وكما نلاحظ أعلاه أن أغلبهم من غير أهل الاختصاص، وهو ما يثير الشك والريبة نحو ما يكتبون، ويطرح سؤالًا: لماذا لم يوظفوا طاقتهم للإبداع في تخصصهم بدلًا عن الاشتغال بما لا ولن يحقق لهم الإبداع؟!
قد يتساءلُ القارئُ: لماذا يجتهدُ المؤلفُ في هذا القسم، في تقديم عروض نقدية لكتب رغم أنه يؤكدُ بين الفينة والأخرى أنها لا تستحق الجهد المبذول؟
والجواب على ذلك: إن غايتنا هي تعريف القارئ الكريم بكل ما كُتب من قِبَلِ جماعة التاريخ المُقَنّع، كي لا يقع في إغراءات تعدُّدِ المؤلفاتِ المُكررة أفكارها، والمتنوعةِ رُقعِها الجغرافية المُتخيلة، فيتكرس ذلك في ذاكرته الجمعية كمسلمات؛ وهو غاية ما يجتهدُ هؤلاء لغرسه في ذاكرة الأمة.
ختامًا: وبعد هذا الموجز الذي تضمن ومضات بسيطة مما جاء في الكتاب، لا بد من القول إن كتابنا هذا لا يعني أنه قد غطى كل صغيرة وكبيرة، فهذا يحتاج إلى عمر مديد وعافية، ومؤسسات تتبناه، ومراكز بحثية متخصصة، ولكن حسب المؤلف أن ما قدمه يُسلط الضوء على هجمة فكرية ترتدي ثوب التاريخ، بغير تخصص ولا اختصاص. كما أنه لا يخلو من التقصير والقصور، فهو كأي مؤلَّف اجتهد صاحبُه وقدّم ما رآه صوابًا، في حين قد يختلف معه أو يتفق آخرون أو يضيفون جديدًا، وهذا أمر طبيعي في مسالك العلم وشعابه، بل هو المطلوب لتحريك العقل وتثويره، فلا كمال إلا لكتاب الله.
ومع ذلك نؤكد أن هذا الكتاب يعد بمثابة “مكتبة مصغرة” حوت توجهات وتصورات وأطروحات “جماعة التاريخ المُقَنّع” من خلال الدراسات السابقة التي تناولت أجزاء منها، أو الكتب العديدة التي ناقشها وكشف عن جوانبها وزواياها المعلنة والمضمرة.
شكر وتقدير:
أتوجه بالشكر الجزيل إلى دار نشر ومكتبة زهراء الشرق بالقاهرة، ومديرها الخبير الخلوق الحاج محمود حجاج، الذي اهتم بهذا الكتاب منذ تسلمه في فبراير 2025م حتى صدوره، وتبنى طباعته على نفقة الدار.
والشكر موصول كذلك لكل من:
زميلي الذي عملت معه بجامعة طيبة بالمدينة المنورة المتخصص بالكتابة الهيروغليفية (المصرية القديمة) بجامعة سوهاج بجمهورية مصر العربية أ.د محمود الزراعي على تزويدي بعدد من النصوص المكتوبة بالهيروغليفية والتي تذكر (فرعون)، وقد قام بترجمتها، وقمت بنشرها في الكتاب مصورة ومترجمة وموثقة من مراجعها ونسبتها لسعادته كحق فكري له أعتز به.
وكذلك أشكر زميلي الذي عملت معه بجامعة أم القرى، أ.د إبراهيم محمد بيومي مهران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، على تزويدي بصورة كانت تنقصني لجزء من تمثال الملك لمصري شيشانق الأول. وقد أشرت إليه في الكتاب كحق له.
وكذلك الشكر للأخ الدكتور صلاح الحسيني الذي زودني بعدد من المقالات الأجنبية، والأستاذ محمد عطبوش الذي زودني بالدراسة النقدية القيمة التي أعدها أ.د محمود أبو طالب وتناولت أطروحات د. كمال الصليبي، كما زودني بمقالتين أجنبيتين لرأي الغربيين في أطروحات د. كمال الصليبي لكل من (الفريد بيستون)، و(هاموند).
ومن الله التوفيق..
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ الأحزاب (56)
أ.د عارف أحمد المخلافي
22 محرم 1446ه
17 يوليو 2025م