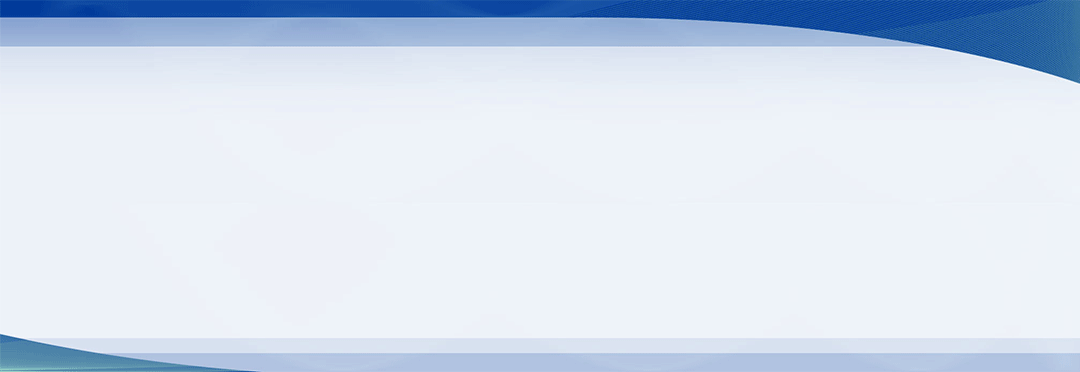أين الكتاب؟ أجبته: لم أوفّر ثمن شرائه بعد

يوسف البارودي:
حصلت على مقعد في ثانوية مولاي إسماعيل التأهيلية، لكنّ أستاذ اللغة العربية طردني ورفع بي تقريرًا إلى الإدارة منذ الحصة الأولى. لم أكن أملك كتاب اللغة العربية. وقف أمامي وسألني:
أين الكتاب؟
أجبته: لم أوفّر ثمن شرائه بعد، لذلك لا أتوفر على الكتاب في الوقت الحالي.
أطلق ضحكة مجلجلة، ثم قال بصوت حازم وهو يشير إلى باب القسم:
الزنقة.
رجوته قائلًا: أستاذي، لقد قطعت حوالي ثمانية كيلومترات مشيًا على الأقدام. أنا متعب.
صرخ في وجهي وهو يضرب بكفه على الطاولة:
الزنقة هي الزنقة. الزنقة الآن.
في تلك اللحظة التي أعقبت سكون صرخة الأستاذ، لا أعرف من أين خرج ذلك الوحش الذي دفعني لأنطّ وأقف فوق الطاولة، ثائرًا في وجهه:
الدّينديمّاك آشمن زنقة. خلّيني نقرا.
ثم لم أعد أتذكر كلّ الشتائم البذيئة التي رميت بها أستاذي. كنت دائم الخجل أمام كلّ الأساتذة الذين درسوني، حتى إنني في بعض الأحيان لم أكن أقوى على النظر في عيونهم. كنت خجولًا وخائفًا، لكنّ وحشًا كان يكبر بداخلي لم أكن أعرفه. وقد خرج الآن ليحل محل يوسف الخجول والخائف.
توصلت بقرار المنع من مواصلة الدراسة بالثانوية عن طريق الحارس العام. لم يكن هناك من يدافع عني، إذ إن التلاميذ الذين كنت أشارك معهم في احتجاجات مع بداية الموسم الدراسي لم يهتموا لأمري. كانوا جميعًا يعلمون أنني ممنوع من الدخول إلى الحصص الدراسية. قررت مغادرة الثانوية نهائيًا بعد أسبوع من قرار المنع.
أمضيت أسبوعين أعيش على هذا الحال: أنام صباحًا وأقضي المساء في مقهى أتعاطى الكيف والسجائر. بعد منتصف الليل أتسلل إلى البيت. أقرأ سلسلة قصص بوليسية عثرت عليها في خزانة أختي. ذات ليلة عدت إلى البيت، وجدت أمي في انتظاري. سألتني إن كنت أرغب في العودة إلى الدراسة، لكنني أجبتها رافضًا. ثم قالت لي: هذه حياتك، لكنني لن أعمل خارج البيت وداخله لأعيل شخصًا لا يفعل أي شيء في حياته.
قلت لها: أنت على حق. ثم انزويت في فراشي.
كنت قد سئمت من الإذلال في المهن المختلفة التي اشتغلت فيها أيام العطل، وكان من الصعب أن أقرر ماذا أفعل بحياتي. فكّرت في العودة للعمل مع “المعمر” لكنّ الفلوجة أخبرني أنهم تحت أنظار مراقبة الدرك. فكّرت أن أهاجر: لكن أين يمكنني أن أهاجر؟ كيف يمكنني أن أهاجر؟ لقد مات كثير من الناس الذين أعرفهم أو أعرف عائلاتهم في عرض البحر. غطيت وجهي وفكّرت: في الصباح سأنهض باكرًا وأذهب للبحث عن عمل جديد.
عثرت بلا عناء على عمل كمساعد لبائع النعناع في سوق باب الحسيمة. لكنني سرعان ما ضقت ذرعًا بتوجيهاته ووساوسه، فقررت أن أصير تاجرًا صغيرًا. كان من السهل أن تكون تاجرًا في سوق باب الحسيمة؛ يكفي أن تعرف سائق العربة ذو القدم المكسورة، بائعة جلود الوحوش ذات الوجه الأسمر، بائع النعناع، الحوّات الضخم، بائعة الرغيف وسط المدينة صباحًا، راعية الماعز عند آخر الجبل قبل سقوط الشفق الأخير، بائعة الدجاج ذات الوشم الأخضر، بائع اللبن الذي أهداني كؤوس السيكوك، بائع البيض الذي ينام فوق بيضه ولا ينكسر، الرجل الهرم الذي قال لي بالإسبانية: يجب أن تبيع النعناع أكثر من المعدنوس! ولم أفهمه حتى رأيت ذبول أوراق النعناع، النشال الصغير الذي علمني كيف أسرق السجائر، الشحاذة التي لعنتني في الصباح حين طلبت مني الولاعة فمددت لها علبة الثقاب، والحشاش الذي طلب مني شقف الكيف وكدّسه في جيبه وزعق في وجهي صارخًا:
امشِ تقود وإلا سأقتلع عينيك بهذا السبسي.
وسط هؤلاء الناس، كنت أرتاح خلف صندوق الكرتون كل صباح أراقب السلعة وأنتظر قدوم كوب الشاي من مقهى باكو مع كسرة حرشة من الخباز السوسي. ما الهدف من الدراسة في الأخير؟ ماذا تعلمت غير الخوف الموحش الذي تسلل إلى ليالي وصار يدفعني إلى الغرق في بحر العزلة؟ متى سيصبح العالم خاليًا من الأشياء التي تثير الرعب في نفوس الناس؟
الجزء السادس أنشره قريبا