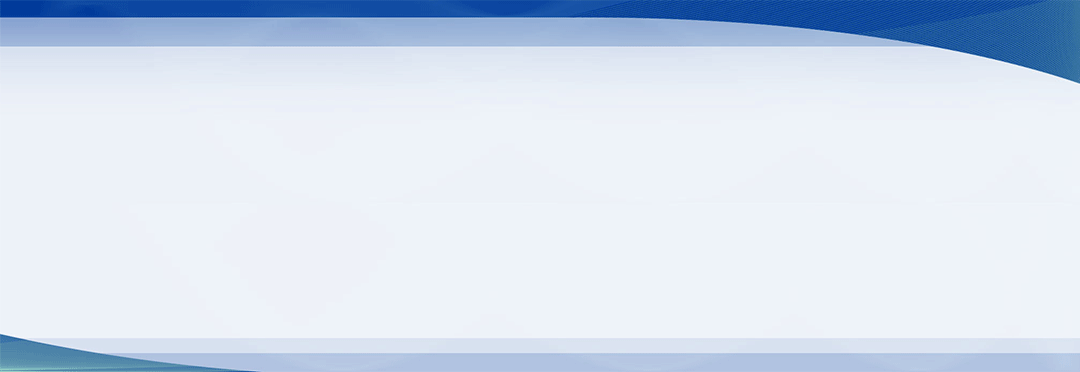سيرة حميمية للهجة مركّبة

إحسان:
تحكي لي أمّي موقفًا أحبّه من طفولتي المبكّرة، يوم عدتُ ناقمةً من الروضة قبل أكثر من ثلاثين عامًا، أشكو خالتي – رحمها الله – الّتي زارتِ الروضة لتعطي ابنتها بيضةً مسلوقة دونًا عنّي، تقول أمّي بأنّي كنتُ أردّد وسط حشرجتي كلمةً لم تفهمها أوّل الأمر: “أنا أبسرتهم.. أنا أبسرتهم”، حتّى فطنت جدّتي – رحمها الله – بأنّي أحاول استخدام اللهجة الصنعانية لأقول بأنّي أبصرتهم أو رأيتهم.
أحببتُ صنعاء كثيرًا، ودأبتُ على إتقان لهجتها لا لتجنّب سخرية الآخرين من لهجتي العدنية فحسب، بل لأنّي تمنّيتُ حقًا أن أصبح صنعانية. كان الانتماء لمدينتي المعشوقة حلمًا من أحلام الطفولة، لكنّ لساني العدني المتموّج كالبحر، السّاكن كالبراكين الخاملة، والملوّن كميناءٍ عتيق، كان أرقّ من أن يحمل لحن السهول والأمطار والرعود، وأصبحتْ محاولاتي البائسة هدفًا جديدًا للتنمّر.
“اسمعوا إحسان كيف تبدو مضحكة وهي تحاول تكلّم الصنعانية”، أتذكر سخرية صديقاتي المقرّبات وهنّ يحوّطن طاولتي، أتذكّر الأيّام الّتي قضيتها في الساحة معتزلةً الجميع لأنّي لم أعد أعرف كيف أكون دون أن أكون غريبة، ولأنّ ألف قافٍ مجلجلة وجيمٍ معطّشة لم تكن كافية لإذابتي بينهن.
كنتُ أستعيد هذه الذكريات أثناء سماعي لحلقة كتبيولوجي “ليش العامية أحسن من الفصحى؟”، حين وجدتُ نفسي محامية للنصوص والروايات العامية، ورغم أنّي لا أكتب إلاّ بالفصحى، إلاّ أنّي أمقتُ المتعصّبين لها، وأودّ لو حصل كلّ فرد على فرصة التعبير باللهجة الأقرب إليه. أوقفتُ الحلقة وسألتُ نفسي: “ماذا عنّي؟ أيّ لهجة سأختار لو كتبتُ بالعامية؟”، لكنّ الاختيار كان مستحيلاً، فالكتابة بأيّ لهجة سوى الفصحى تعني أن أسرق أصوات الآخرين الّتي فشلتُ في الذوبان فيها حتّى بعد سنواتٍ من المحاولة، وعادت بي الذاكرة إلى قصّة “أبسرتهم”، وإلى الأيّام الصيفية الدافئة في صنعاء، مشروب البابايا البارد وحبّات الخوخ الرائبة وقراءة ماجد في صالة جدّتي رحمها الله.
عرّفتني مجلاّت الأطفال على حقيقة أنّ الفصحى تختلف عن العاميّة في انتمائها لكل العرب دون تمييز، وهي قابلة للتعلّم، أنيقة، محبوبة، لن يمنعني أحد من أن تكون لي، ولن أخسر انتماءاتي بتبنّيها، بل لعلّها تهيؤني للانتماء إلى مجموعة أوسع من النّاس، هكذا كان إتقان الفصحى يسيرًا علي، إذ تعلّمتُها تحت الرغبة بالانتماء والجوع للقبول، ثمّ أدركتُ بعد عقدين، بأنّها لا توفّر ذلك فحسب، بل وتعطيني سلطة ناعمة، وأصولاً في عالمٍ لا أملك فيه شيئًا.
Photo by darylfigueroa on Unsplash
عندما بلغتُ الثانية عشرة، انتقلنا من صنعاء إلى جدّة مع خبرة مسبقة في التعامل مع مجتمع مختلف عن مجتمعي الأسري، وكنتُ أجلس مع قريبة لي مولودة في جدّة عندما حذّرتني من استخدام لهجتي في المدرسة: “اسمها أبغى.. انتبهي تقولي أشتي”، أبغى أبغى أبغى، كرّرتها طوال الوقت مخافة أن تزلّ لساني، حتّى إذا دخلتُ الفصل في اليوم الأوّل، انتابني الجزع وقرّرتُ التزام الصمت والإجابة إذا اضطررتُ بـ “نعم ولا”، أو بشكل أدق “ايه ولا”.
لكنّ “ايه” الّتي حاولتُ بها مواراة نقائصي، تحوّلت إلى سببٍ للانتقاص، وعلى كل حال، لم تكن إجاباتي الثنائية مستدامة، واضطررتُ للتلفّظ بجملٍ كاملة، وإذ بلساني يعوجّ بصنعانية هزيلة بعد أن حملته لسنين على ذلك، وتعمّق شعوري بالضياع وباحتقار النّفس، فصمّمتُ على تبنّي هذه اللهجة الجديدة حتّى لو كلّفني ذلك التعرّض للسخرية.
وكنتُ أقضي أوّل دقائق من الفسحة في زاوية الفصل مع شلّة من البنات يطرحن علي أسئلة عشوائية، فأجيبهنّ باستفاضة وسذاجة لمّا ظننتُ بأنّهن يواسين غربتي، وبأنّ لهجتي بدأتْ بالتحسّن، حتّى أوقفتني الطالبتان السعوديتان الوحيدتان في الفصل: “لا تستجيبي لهنّ، لا يسألنكِ إلاّ لمحاكاة لهجتك والسخرية منها”، كنتُ في حالة صدمة لم أستوعبها إلاّ بعد سنوات، حين أدركتُ بأنّهن ما نبذنني إلاّ لأنّي كنتُ اللهجة الّتي وارينها عن بعضهن واقفةً على قدمين!
اقترحت علي الفتاتان السعوديتان مرافقتهما وقت الفسحة لتحمياني من الايذاء، كانتا وقورتين ولطيفتين، إحداهما سوداء طويلة ونحيلة تزين ظفائرها بالإكسسوارات الفضّية، والأخرى زهرانية بيضاء ينسدل شعرها الرقيق حتى أذنيها. أخجل من نسياني اسميهما، فقد عرّفتاني على فتيات من جنسيات مختلفة، رحتُ أنصتُ لهن بانتباه، وأدرس اختياراتهن اللغوية، مخارج الحروف، إيقاع المفردات عندما توالف جملاً طويلة، وسرعان ما أدركتُ بأنّ اللهجة الجداوية* تشترك مع العدنية في الإيقاع الساحلي السلس، وفكّرتُ بأنّى لو توقفتُ عن المقاومة على الطريقة الّتي كنتُ أقاوم بها في صنعاء لسهل اكتسابها علي، ولدهشتي فقد نجحتُ خلال أشهر معدودة، ولم يكن أحد ليحزر بأنّ فترة إقامتي في جدّة لم تتجاوز عامًا واحدًا آنذاك.
من الصعب تجاهل مأزق الهوية عندما نتحدّث عن اللهجات المتصارعة، لكنّي أرفض أن أكون الغراب الّذي قلّد مشية الطاووس، لقد ربّيتُ ثلاثة طيورٍ في لساني، تنقر بعضها بعنادٍ طفولي، الطائر الجدّاوي طموح ومثابرٌ وعنيد، والطائر الصنعاني عجوزٌ مضربٌ عن التغريد ويكره دوافعي القديمة لتبنّيه، ولم يكن ذنب الطائر العدني الخجول إلاّ أن تورّط معي منذ البداية.
في مرحلةٍ ما قبيل إتقاني للهجة الجدّاوية، قرّرتُ إيقاظ طائري الرابع، طائر الجنّة المتعالي على سائر الطيور، صاحب الأجنحة الذهبية، والمنقار الرخامي، والغناء المهيمن، فبدأتُ أستخدم الفصحى في المدرسة مدّعيةً أنّا نتحدثها في المنزل، وعندما كانت المراهقات يجلبن صور شاروخان وأشرطة كاظم الساهر، كنتُ أجلب الكتب التراثية وأستعرض بقراءتها، هكذا استخدمتُ مواهبي الأدبية منذ عمر مبكّر لإيجاد موقعٍ لنفسي في العالم، تريد أن تقصيني بلهجة أرفع من لهجتي؟ انظر إليّ وأنا أعلو عليك بالفصحى.
أفهم الآن بأنّ الأسى الداخلي يضخّم انعكاساتنا السلبية في أعين الآخرين، لكنّي كنتُ مطحونةً تحت انفعالات الغربة، وكنتُ على استعداد لتبنّي أي سلوك يخفّف وطأها علي، وعلى كل حال فإنّ ادّعاء اللسان الفصيح لم يدم لأكثر من أسبوعين في المدرسة، إلاّ أنّ الهوية الّتي منحتني إيّاها الفصحى، تبلورت ونضجت عبر السّنوات، لتصبح الكتابة ضرورة وجودية بالنّسبة لي، إذا توقفتُ عنها، أتوقف عن الوجود وأعود لحالة التمزّق المربكة، ولعلّ هذا ما يجعلني شرسةً أمام محاولة فرضها على من لا يحبّها، فاللغة مسألة شخصية وحميمية بالنسبة لي، ولطالما تخيّلتها كذلك بالنسبة لغيري.
أعود للهجة العدنية، لقد أدركتُ منذ وقتٍ قصير بأنّي لم أمارس هذه اللهجة خلال حياتي إلاّ في نطاقٍ أسري، حتّى أنّي أتلعثم أمام إلحاح صديقاتي علي بالتحدّث بها، إذ كنتُ في الرابعة من عمري آخر مرة زرتُ فيها عدن، لكنّ المدهش حقًا هو عقلي الّذي يصنّف كلّ من يتحدّث العدنية على الإنترنت في خانة أهلي، فليس سوى أهلي من يتحدّثها، وليس سوى أهلي من يطبخ الزربيان في المنزل، ويحتقر أظرف الشاي العدني الجاهزة.
عندما أتصفّح حساب ناس عدن، أحسّ بغرابة الانتقال إلى عالم آخر، حيث استخدام لهجة أهلي ليس مقبولاً فحسب، بل وطبيعيًا أيضًا، هناك مدينة في الكرة الأرضية حيث يمكنني تخفيف قيودي اللسانية، إلاّ أنّ هذا الشعور المغتبط يخالطه شيء من الحزن، أيحق لي الانتماء إليهم أنا التي لم تكتوي بصيف عدن الحارق يوم تنقطع الكهرباء؟ أيحق لي ادّعاء الهوية العدنية طمعًا في الأصالة وأنا التي قضيتُ عمري أتحرر من لهجتها؟ ماذا عن صنعاء؟ ما الّذي أملكه فيها سوى النوستالجيا المعذّبة؟ وجدّة الّتي احتضنتني معظم سنوات عمري، أيكون لي أن أنسب نفسي إليها؟
أزيح كلّ هذه الأسئلة بعيدًا، أضع جهازي المحمول على طاولةٍ خشبية في مقهى مختصّ في الرياض، يقدّم لي الموظف كوب القهوة ويسألني عن سبب غيابي عن المقهى، أشكره بالإنجليزية، أفتح مستندًا جديدًا في قووقل، أوقظ طائري الفصيح، ليطبق على قلبي بجناحيه، ويهمس لي بالكتابة: “فقط إذا أصبحتِ كاتبة ناجحة، حُق لكِ الانتماء إلى أي مدينة تريدين”.
• أعني باللهجة الجداوية هنا، اللهجة المستخدمة في حاضرة المدينة حيث التنوّع الدمغرافي الّذي خلق لهجة بسيطة وسلسة.
• كتبتُ هذا النصّ بطلبٍ من ابنة خالتي الّتي استأثرت بالبيضة المسلوقة.
المصدر: إحسان.