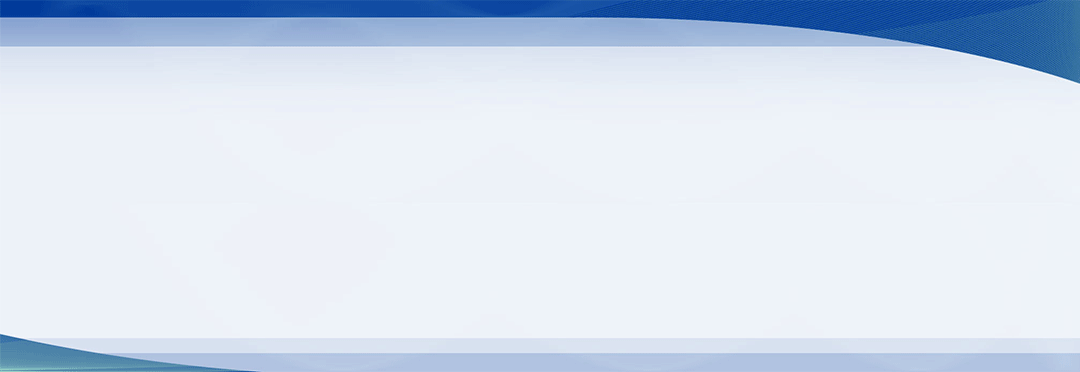الأدب هو كشف واستبصار

حين نتحدث اليوم عن الأدب في بلادنا — خصوصًا في اليمن الذي تتناوبه الاستبدادات والأحزاب والسوق المتوحش — يبدو أننا نتحدث عن شيء آخر غير ما كنا نتصوره ذات يوم؛ ليس عن نشاط روحي يربي الحس ويوقظ الوعي، بل عن منتج قد تُحوَّل قيمته إلى سلعة أو أداة في خدمة جهة معينة.
الأدب، في أحسن تعريفاته، هو كشف واستبصار كما أراه، لأنه يعمل على فتح نوافذ داخلية أمام القارئ، يمنحه بُعدًا يطلّ من خلاله على العالم ويعيد تشكيل فهمه للواقع. لكن عندما لا تُلصق الكلمات بالواقع — لا بالوقائع وحدها بل بالمسافة التي تخلق الحلم والتأويل — نصبح أمام مرآة مشوهة لا تعكس سوى صورة باهتة.
اليوم، في صالون “أرنيادا” الذي نسعى من خلاله لتعزيز الثقافة عبر مناقشة أسبوعية لكتاب محدد، كنا على موعد مع كتب عبد العزيز المقالح، وهي باكورة أعماله الشعرية. ومن خلال هذا الصالون نحاول كل أسبوع خلق تجربة ثقافية. وبقدر ما كان للكتاب من أهمية، كنا نتمنى أن تكون الجلسة احتفالًا بالنص وملتقى للناس حوله، لكن الحضور لم يتعدَّ بضع وجوه، مقارنة بما ينبغي أن يكون. في كل أسبوع أقول أمام هذا الحضور القليل: ماذا لو كان المكان معرضًا للأحذية، أو لقاءً لمشهورة، أو اجتماعًا حزبيًا لصالح جهةٍ ما؟ لامتلأ قبل أوانه.
هذا مثال صارخ على أن الاهتمام العام بات مرهونًا بآليات أخرى: التسويق السياسي، التسويق السلعي، الولاءات الحزبية، وسوق العروض. الناس اليوم يتوخون السلامة؛ يتجنبون الكتابة من أجل الوطن والوعي، لأن الخطر لم يعد فقط في العنف الخارجي، بل في الخوف من العزلة والوصم والفقدان الاجتماعي، أو حتى الاعتقال. لذا أُجدّد القول: الأدب الحقيقي لا يكتفي بوصف ما هو قائم، بل يخلق مسافة تمكّنه من التفكير، ومن ثم الإيحاء.
في مقالة بعنوان “القراءة وسيلة للوقاية من الانحراف” لمحمد عباس نور الدين في مجلة العربي، تساءل الكاتب: هل هناك علاقة بين الأمية أو بين المستوى التعليمي والانحراف؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يجوز أن نتساءل: هل يمكن أن تمثل القراءة أو المطالعة وسيلة لاندماج الأفراد، لا سيما الأحداث، في المجتمع وبالتالي وقايتهم من الانحراف؟ ثم يوضح بعد ذلك أن هذه الأسئلة طُرحت في إطار الحملة الرامية إلى القضاء على الأمية وتشجيع القراءة والمطالعة في فرنسا في بداية الألفية الحالية.
ونحن، ماذا لو تساءلنا عن حالنا اليوم؟ وأين نحن من العالم؟ هذه المقالة كُتبت قبل خمسة وعشرين عامًا بالضبط، في العدد 502 لشهر سبتمبر. في ذلك الزمن كانت المجتمعات العربية قد انقسمت إلى ثلاث فئات: فئة ملاحظة منبهرة مستهلكة لكل جديد، فئة رافضة له — وهو الجمود بعينه — وفئة مستفيدة منفتحة متفاعلة معه التفاعل الإيجابي، وهي بطبيعة الحال فئة المثقفين. كان النقاش حينها يدور حول منافسة المعلومات وتطور تقنيات الكتابة السريعة، وهو ما يشبه زماننا الحالي مع ظهور الذكاء الاصطناعي. وهنا نتساءل أيضًا: هل يستطيع المثقف اليوم، من خلال الأدب والتكنولوجيا، أن يتفاعل مع هذه الأدوات تفاعلًا إيجابيًا يسهم في التنوير وإخراج اليمنيين من ظلمات الجهل والتخلف إلى النور؟
خاصة أن الأدب الذي نراه اليوم يميل إلى أن يكون تقريرًا عن الحياة اليومية؛ سردًا مباشرًا، صورًا فوتوغرافية لحظة بلحظة، بلا أسلوب يميز أو رؤية تعمّق. ورغم انتشار هذا الشكل، يظن أصحابه أنهم يقربون النص من القارئ، لكن النتيجة عكسية: تفقد اللغة حدّتها، ويذوب النص في الهوامش، فلا نحصل سوى على وصف سطحي للحياة، لا يغيّر الوعي ولا يفتح أفقًا جديدًا.
الحياة ليست بحاجة إلى تسجيل مستمر كما لو كانت كاميرا مراقبة؛ هي بحاجة إلى إعادة خلق، إلى منحها اسمًا وفهمًا جديدين. فالإنسان لا يُصنع من الحياة فقط، بل الإنسان هو من يصنع الحياة، وهذا فعل خلاق لا يتحقق بمجرد سرد التفاهات اليومية.
ولو تأملنا مليًا، لأدركنا فداحة أن الأدب اليوم محاصر أمام تحالف موضوعي بين السوق والسلطة: سوق يبتز القارئ بتقنيات التسويق والقنوات الإعلامية، وسلطة تسعى إلى توجيه الخطاب أو تحييده. النتيجة أن الثقافة تتحول إلى سلعة تُعرض وتُستهلك. ولهذا نجد وسائل الإعلام تقيس القيمة بعدد المشاركات والإعجابات، لا بعدد الأسئلة التي يثيرها النص أو العمق الذي يحققه. فيصبح الشاعر والروائي والناقد آلات تنتج نصوصًا وفق مقاسات مسبقة: سهلة، قابلة للتصفح، موجزة، بلا مخاطرة. أما اللغة، فتتحول إلى أداة تغليف منتج، بدل أن تكون وعاء لرحلة إنسانية.
من هنا ينبع خوفي من مصطلحات مثل: الإبداع، الأديب، الشاعر، المثقف، الصحفي… فإذا لم يتحلَّ الكُتّاب بوعي نقدي بموقعهم داخل هذه المنظومة، سنشهد استبدالًا تدريجيًا لمفهوم الإبداع بمفهوم الإنتاج، خصوصًا مع الذكاء الاصطناعي الذي يحوّل النص إلى منتج بمواصفات السوق: يُسوَّق ويُقاس بالزمن والربح، لا بالمعنى والقيمة. والكاتب الذي يقبل بهذه الشروط بلا مقاومة لا يفعل سوى الخضوع.
كثير من كتابنا المعاصرين يقبلون بذلك لأن ثمن الاستمرار وفق نظام السوق يبدو أهون من حرمان النشر كليًا، غير مدركين أن الثمن الحقيقي هو خنق المساحات التي يمكن للنص أن يفتحها. لذلك صارت الرقابة الذاتية بديلًا للرقابة الرسمية، تتجلى في العبارات التي نسمعها دومًا: «هل تريد أن تتعرض للسجن مثل فلان؟ أو للملاحقة من أجل مقال أو كتاب؟ لا، الحياة أثمن». بالنسبة لهؤلاء حياتهم الشخصية أهم، لكن غياب الإبداع وخنق الأصوات يحرم المجتمع من إحدى ركائزه الأساسية: القدرة على رؤية نفسه، على النقد الذاتي، على تصور بدائل. عندها يفقد وعيه ويغدو مجرد آلة استهلاك.
الأدب الذي لا يجرح ولا ينهض بالعقول يصبح على هامش الحياة. وإذا لم يعش الفن داخل الناس كحياة تتنفس، سيتحول إلى ديكور جميل يعلق على جدران الجهل.
النموذج الذي نعيشه اليوم يعلّمنا الكثير: جمهور يطوّق أشياء تافهة معاصرة بينما يمر أمام لوحات الأفكار والكتب الفكرية بلا اكتراث؛ تاريخ الإحساس يُختزل أمام لافتة تجارية أو اسم ملفت. في مجتمع فقد القدرة على التمييز بين الثمين والزائل، يصبح الأدب بلا جمهور، لا لأنه بلا قيمة، بل لأن النظام العام — السوقي والسياسي معًا — أعاد ترتيب الأولويات بما يناسبه. وإذا أردنا مقاومة ذلك، فعلى الأدب أن يستعيد دوره الأصيل: أن يكون آلة كشف لا آلة وصف؛ أن يكون استبصارًا لا سوقًا.
الكتابة التي تُحارب اليوم ليست مجرد خطاب معارض، بل محاولة لإنقاذ الكينونة الإنسانية في لحظة تضارب قيمي وسياسي لا نعلم نهايته في اليمن والعالم أمام الرأسمالية. لذا يجب أن يتسلح الكُتّاب بالوعي: وعي سياسي واجتماعي وأيديولوجي، ووعي تفكيكي لطريقة إنتاج النص وطرائق تسويقه.
لا يكفي أن نكتب لنكون آمنين؛ يجب أن نكتب لننزع الخوف من النفوس، لننشئ ساحة بديلة للحوار، لنسائل ما حولنا ونعيد تعريفه. على المثقف أن يتعلم كيف يصنع نصًا لا يبرد في اليد عند أول ضغط من السلطة أو السوق، نصًا يملك القدرة على الإزعاج البناء، لا الإزعاج العابر.
أخيرًا، لا يمكن أن نغفل أن الأدب في اليمن يعيش اليوم بين التضييق والتشتت، بين الحاجة إلى التمويل والخشية من الانزلاق في أطر ضيقة تخدم جهات بعينها. وهذا ما أراه واقعًا مع كثير من الكُتّاب والمثقفين الذين انجرفوا وراء ذلك. إن استعادة الأدب لصحته ليست مسؤولية الكُتّاب وحدهم، بل مسؤولية المجتمع بأسره: جمهورًا، مؤسسات، نقابات، وفضاءات ثقافية حقيقية لا تُقاس بمقاييس السوق الضيقة.
الأدب حين ينجح في الكشف والاستبصار يكون قد أعاد للإنسانية جزءًا من ذاتها؛ وعندما يفشل، يخسر المجتمع نعمة رؤية نفسه.
علينا إذن أن نرفض أن نكون آلات إنتاج أدبي، وأن نتمسك بمسافة الكلمات عن الأشياء، بمقدار من الخيال هو الضريبة الضرورية لرؤية أعمق. الأدب كشف واستبصار، وإذا أردنا له أن يبقى كذلك في زمننا هذا، يجب أن يُعاد خلقه يوميًا، من الداخل، ومن دون خوف.
صابر الجرادي