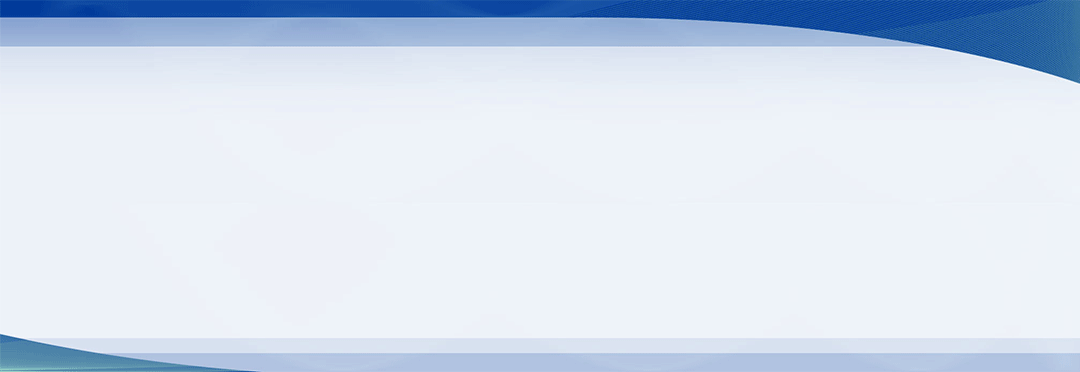نزع القداسة عن السياسة شرط أساسي للديمقراطية

رواها 370 اسماعيل الصنوي عدن
ليست الديمقراطية مجرد آلية تقنية لتداول السلطة أو ممارسة دورية للاقتراع، بل هي قبل كل شيء بنية رمزية وثقافية تقوم على افتراض جوهري مفاده أن لا أحد يمتلك الحقيقة، وأن كل سلطة قابلة للخطأ، وكل قرار قابل للنقد، وكل نظام قابل للمراجعة. فالديمقراطية لا تعيش في الصناديق وحدها، بل في المجال المفتوح للنقاش والمساءلة، حيث لا تُمنح الأفكار حصانة أخلاقية، ولا تُعامل المؤسسات ككيانات معصومة، ولا يُرفع الأشخاص إلى مرتبة فوق النقد. ومن هنا، فإن أخطر ما يهدد المجال السياسي ليس الفساد في ذاته، بل تحوّل السياسة إلى مجال مقدس، تُقدَّم فيه السلطة بوصفها تجسيدًا لإرادة عليا، وتُعامل قراراتها كحقائق نهائية لا يجوز مساءلتها، سواء استند هذا التقديس إلى الدين، أو إلى التاريخ، أو إلى فكرة الأمة، أو إلى هواجس الأمن والاستقرار. في هذه اللحظة تحديدًا، يفقد المواطن صفته كفاعل سياسي، ويتحوّل إلى تابع أخلاقي، يُطلب منه الإيمان بدل الفهم، والتصديق بدل التفكير، والطاعة بدل المشاركة. السياسة، في جوهرها العميق، ليست مجالًا للحقيقة المطلقة، بل فضاءً بشريًا خالصًا، تحكمه المصالح المتغيرة، والتوازنات النسبية، والصراعات القابلة للتفاوض. إنها ليست ميدانًا للفضيلة، بل حقلًا لإدارة الاختلاف، ولا تهدف إلى تحقيق الانسجام الكامل، بل إلى تنظيم التوتر داخل المجتمع بحيث لا يتحول إلى عنف. وكل محاولة لإلباسها طابع القداسة لا تعني أخلاقتها، بل تحصينها من النقد، أي نقلها من مجال العقل إلى مجال الإيمان، ومن فضاء السياسة إلى فضاء العقيدة. إن القداسة في السياسة لا تنتج استقرارًا حقيقيًا، بل تخلق وهمًا بالتماسك يخفي تحته هشاشة بنيوية عميقة. فالسلطة المقدسة لا تُصلح أخطاءها لأنها لا تعترف بوجودها، ولا تطوّر أدواتها لأنها ترى نفسها كاملة، ولا تصغي لمواطنيها لأنها تفترض امتلاك الحقيقة مسبقًا. وهكذا تتحوّل الدولة من كيان تعاقدي بين أفراد أحرار، إلى جهاز وصاية أخلاقية يمارس الحكم باسم “المعنى” لا باسم الإرادة الشعبية، وباسم “الصواب” لا باسم التوافق.
الديمقراطية، في معناها الفلسفي، هي مشروع “تدنيس إيجابي” للسياسة، أي إخراجها من دائرة المطلق إلى مجال النسبي، ومن منطق العصمة إلى منطق الخطأ القابل للتصحيح. فهي لا تقوم على فكرة الحاكم الصالح، بل على نظام يحد من فساد أي حاكم، ولا تراهن على أخلاق الأشخاص، بل على بنية مؤسساتية تجعل الانحراف مكلفًا، والخطأ مكشوفًا، والسلطة خاضعة للمحاسبة لا للتقديس. ولا يعني نزع القداسة عن السياسة الدعوة إلى الفراغ القيمي أو العدمية الأخلاقية، بل العكس تمامًا، فهو شرط لقيام أخلاق عامة حقيقية. لأن الأخلاق التي تُفرض باسم المقدس تتحول إلى أداة هيمنة، بينما الأخلاق التي تنشأ في فضاء حر للنقاش تصبح جزءًا من الضمير الجمعي، لا من جهاز القمع. فالقيمة الأخلاقية لا تكتسب مشروعيتها من سلطتها، بل من قابليتها للنقد والتبرير العقلاني. إن المجتمعات التي لم تفصل بعد بين الإيمان والسلطة، وبين المقدس وإدارة الشأن العام، تبقى أسيرة أنماط حكم أبوية مهما رفعت من شعارات الحرية. فالديمقراطية لا تزدهر في ظل مواطن يُطلب منه التصديق، بل في ظل مواطن يُطلب منه التفكير، ولا تنمو في فضاء محصّن، بل في مجال “مدنس” بالمعنى الفلسفي، أي قابل للشك، للتعديل، وللانقلاب السلمي على ذاته. وفي النهاية، ليس المطلوب إقصاء القيم من السياسة، بل تحرير السياسة من ادعاء امتلاك القيم. فحين تكف السلطة عن تقديم نفسها بوصفها ممثلة للحقيقة أو حارسة للأخلاق، وتقبل بأن تكون مجرد أداة بشرية لإدارة الاختلاف داخل مجتمع متنوع، عندها فقط تبدأ الديمقراطية كواقع حي، لا كشعار مزيّن. فالديمقراطية لا تحتاج إلى سلطة مقدسة، بل إلى سلطة يمكن إسقاطها، ومحاسبتها، وانتقادها دون خوف.